
من تحصيل الحاصل القول إن الإنسان كائن اجتماعي يعيش في حضن الجماعة يتأثر بها ويؤثر فيها. هذا التأثير المتبادل نجمت عنه خاصية لصيقة بنمط حياته وتكسبها ميزة نوعية وهي تنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة بشكل تفاوضي ليكون التعايش وتتكامل الأدوار من أجل الحصول على الاحتياجات الضرورية والكمالية. ومن أهم مظاهر هذا التنظيم السعي الدائم إلى تحسين حال الحياة سواء على المستوى المادي أو النفسي أو الأخلاقي والقيَمي. ولهذ كانت التنمية والأمن القاطرتان اللتان تقودان مسيرة حياة البشر نحو الحضارة والرقي والحياة الكريمة.
وبالرغم من تمايز مفهومي "التنمية" و" الأمن" على مستوى الذهن ، فإنه يعسر الفصل بينهما على مستوى التطبيق الواقعي نظرا للتداخل بين معنييهما ، ونظرا لتقاربهما من حيث الشكل اللفظي حيث يشتركان في أصلين من حروف جذرهما الثلاثي لذا كانت المقاربات التفكيكية التي تحاول التعرض لكل واحد منهما على حدة إجرائية إلى حد كبير. فالأمن والتنمية وجهان لورقة واحدة كما سيتبين من معناهما في الاستخدام الاصطلاحي المتداول .
يعرف الأمن بأنه جعل الفرد أو الجماعة يشعران بالطمأنينة ، وذلك بإشاعة الثقة والمحبة بينهم ، وإزالة كل ما يهدد استقرارهم وعيشهم ، وتلبية متطلباتهم الجسدية والنفسية ؛ لضمان قدرتهم على الاستمرار في الحياة بسلام وأمان. فالأمن عبارة عن منظومة متكاملة تجمع ما بين الحفاظ على قيم وآداب المجتمع وتماسكه وتلبية حاجاته الأساسية وذلك وفقا لإجراءات تؤدي إلى مواجهة كل الأخطار والمهددات الداخلية والخارجية مع مراعاة الوصول إلى مستقبل أفضل يحفظ ما تم إنجازه من تراكمات أمنية وحرية وعدالة وفقا لرؤية أمنية صحيحة ومتزنة.
وتعرف التنمية بأنها عملية ترقية للمجتمع شاملة ومستمرة ؛ تجعله ينتقل من وضع أدنى إلى وضع أعلى وأفضل ، وذلك بحسن استغلال الطاقات المتاحة وتوظيفها بشكل أكثر نجاعة وعقلانية لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتصل إلى مستوى الرفاه ، ولتوجيه الجهود وتنظيمها حتى تندمج في حياة الأمم الأخرى وتسهم في تقدم البشرية بأفضل ما يمكن.
يتضح لنا مدى الترابط والتداخل بين مفهومي الأمن والتنمية. ففي تأكيدنا على أن التنمية تعد عنصرا أساسيا للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، فإننا قد أقررنا بأنها تمثل عنصرا مساعدا على الأمن، وإذا اعتبرنا أن الأمن يعد ركيزة كبرى لانطلاقة تنموية ناجحة ، فإننا قد أقررنا بأن التنمية لن تتحقق إلا إذا تعزز الأمن وعمت الطمأنينة جميع مكونات المجتمع . فالأمن والتنمية عنصران متلازمان ومترابطان، وأي خلل في أحدهما ينعكس سلبا على الآخر.
وتعزز التجارب التاريخية هذه العلاقة القوية بين المفهومين ، فتؤكد كتب التاريخ أن الأمم التي ازدهرت وتطورت كانت تنعم بالأمن والاستقرار ولو لم تكن ثرواتها بالغة الأهمية . وقد أكد هذه العلاقة رجل الاقتصاد الهندي "امارتيا كومار صن "، الذي كان له الفضل في تصور مؤشر التنمية البشرية ، فدعا إلى العمل على تحقيق هدفين لخلق تنمية شاملة ومتوازنة هما: التخلص من الخوف، والتخلص من العوز.
ولقد أثرت دعوة رجل الأعمال الهندي على سياسات المؤسسات الدولية فاعتمدت مؤشرا جديدا للتنمية يأخذ في عين الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان الأخلاقية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ، فجعلت في سلم أولوياتها العمل من أجل القضاء على الفقر والجهل ، والسهر على تعزيز الديمقراطية ، والسعي في مكافحة الصراعات والنزاعات.
وباعتبار الأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها وديمومتها ، فقد حرصت موريتانيا على الاهتمام بالأمن في الداخل وعلى الحدود واعتباره من أهم الواجبات الرسمية فسخرت له إمكانات مادية وبشرية معتبرة باعتباره المطلب الأساسي للمجتمع المحلي والدولي وبتحقيقه تنطلق مشاريع التنمية . ولقد ركزت المقاربة الموريتانية للأمن على أن تعثر التنمية وانخفاض دخل الفرد يؤديان لا محيد إلى الانفلات الأمني والتسيب مما يؤدي إلى انتشار مختلف الجرائم التي تبدأ بسيطة هدفها سد الاحتياجات الضرورية ثم تتطور مع الوقت لتتحول إلى جرائم منظمة تقف وراءها مؤسسات إجرامية عابرة للحدود.
إن تحقيق التنمية والأمن لابد أن ينطلق من واجهتين: داخلية وخارجية.فعلى المستوى الخارجي لابد من العمل على صعيد العلاقات الدولية لاستقرار التنمية والأمن المحلي. أما على المستوى الداخلي فلابد من الاهتمام بالأمن الداخلي للوقوف أمام أي تغيرات أو تقلبات سلبية تحدث لسبب ما خصوصا مع بروز بعض الظواهر الشاذة في مسلكيات الأفراد وتصرفاتهم ، نجمت عن التطور العمراني والمجتمعي والانفتاح على العالم بحيث لم يعد بإمكان مناهج التعليم ولا قواعد التربية الأسرية ولا تأطير المنظومة الأخلاقية التعامل معها بالكفاية اللازمة مما يتطلب وضع رؤية اجتماعية مشتركة ومتعددة الواجهات.
ولاشك أن لأجهزة الأمن دورا فعالا في الحفاظ على معادلة "الأمن والتنمية" فلا تحدث تنمية إلا من خلال استقرار الدولة وسيادتها على أراضيها ، كما أن لمنظمات المجتمع المدني هي الأخرى إسهامها في هذا المجال .
لقد ظلت العلاقة بين الأمن والتنمية قوية وحتى في حقبة فهم الأمن كنشاط لصيق بالدولة في ظل نظام ثنائي القطبية تتصارع فيه الدول باعتباره تكافؤا في الرعب من الناحية العسكرية والمعلوماتية.ولقد زادت أهمية هذه العلاقة مع ظهور تهديدات أمنية جديدة ذات طبيعة مغايرة تتعلق بالأفراد، والجماعات، والقوميات والشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات الدولية، التي أصبحت المرجعية الأساسية في التحليل الأمني وتم التراجع عن النظرة التقليدية القائمة على فكرة حماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية. وهو ما أعطى الأولوية لإعادة تعريف الأمن بأنه العنصر الفاعل في التنمية.
ويقر علماء التنمية والأمن أن الأزمات الاقتصادية وما يترتب عليها من عواقب سلبية مثل: التضخم، والفقر، والبطالة هي المسؤولة في الغالب عن الشروخ والفوارق الاجتماعية الكبيرة التي تمهد الأرضية الخصبة للأنشطة الإرهابية ؛ والاحتقان المجتمعي حيث يزداد الفقير فقراً ، والغني غنى . وهذا الوضع يعتبر عاملاً رئيساً من بواعث الإرهاب الذي هو في أغلب تجلياته نتيجة الحرمان وعدم العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية ، وعدم الإشراك في الرأي والمشورة، وعدم المساواة في الفرص، وتقييد الحريات المكفولة.
ويجب أن تكون معالجة ظاهرة الجريمة والإرهاب ومكافحتها عملية استباقية ، تستشري في المستقبل وتخطط له وفق تفكير وقائي، له قوة إقناع تجعل المعنيين وأنصارهم المتعاطفين معهم يتخلون بمحض إرادتهم عن أعمالهم المدمرة ، ويتحركون في مسارات آمنة تخلو من العنف.
===
وبما أن الجريمة والإرهاب والتطرف والتصدعات المجتمعية كلها من مخرجات عدم الأمن وانعدام التنمية، فقد عملت موريتانيا على خطط واستراتيجيات كانت لها نتائجها الإيجابية لإرساء الأمن خاصة على طول حدودها الشرقية حيث تنشط الجماعات المسلحة، وعصابات تهريب المخدرات والسجائر، وشبكات تهريب المهاجرين السريين. كما دفعها هذا المشغل إلى المساهمة في مبادرات إقليمية ودولية تهدف إلى الحد من هذه المعوقات المهددة للدولة والمجتمع، وتعين على حسن تسيير وإدارة الموارد، وترسيخ الثقافة الديمقراطية بما تعنيه من مشاركة شعبية تكفل تفريغ الاحتقان، وتضمن تدشين أسس متينة لاندماج اجتماعي متكامل.
وتقوم المقاربة الموريتانية على مسارين متكاملين: أحدهما وقائي والأخر علاجي.يسعى المسار الوقائي إلى تجفيف منابع التطرف العنيف والقضاء على البيئة الاجتماعية الحاضنة له،كما يعمل على صياغة حلول ناجعة لمتلازمة التنمية والأمن بغية تحصين الشباب ودمجه.ويأتي ذلك في رؤية تقوم على اعتماد تنمية شاملة ومتكاملة ومندمجة تزيد من فرص حياة جميع الأفراد وتأخذ بعين الاعتبار إلزامات التنمية البشرية كرفع القدرات والمهارات في مختلف المجالات، وإلزامات التنمية المستدامة للانتقال بالسكان والظروف الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحيطة بهم إلى وضع أفضل دون الإضرار بالبيئة والتراث البشري وحقوق الإنسان.
ويعتمد هذا المسار الوقائي على جملة من الأدوات ذات طبيعة قسرية ودينية واجتماعية وتربوية وتنموية يمكن تلخيصها في النقطتين التاليتين :
- تعزيز منظومة الأمن والدفاع بإحداث قوة ردع على مستوى التحدي وتأسيس منظومة أمنية ناجعة ومتكاملة تقف أمام العنف الجماعي، وانتشار الجريمة ، وتراجع السلم الأهلي ، والصراع المذهبي والجهوي ، وازدهار الهويات العرقية ، وانتشار المخدرات ، وضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الأهلية وبهيبة الدولة .
- دعم هذه المنظومة بقدرات ذات طبيعة استرتيجية تكملها كضبط مناهج التعليم ، وتصحيح معلومات أصحاب الخطاب الديني ، وتقوية اللحمة الاجتماعية ، والدفع بالاقتصاد نحو تنمية مستديمة ، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ، وتعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني.
أما المسار العلاجي فيأتي مكملا للمسار الأول وهو ذو طبيعة إصلاحية ترمي إلى إعادة تأهيل الشباب المتورط في مثل هذه الأعمال العدوانية وانتشاله والعمل على إقناعه بعدم صوابية الخط الذي ينتهجه وضرورة الرجوع إلى جادة الحق ثم إعادة دمجه في الحياة النشطة.
فالتنمية البشرية والاقتصادية إذا دُعِمَت بنحوٍ صحيح وفعال ونُفِّذَت وفق خطط مدروسة يمكن أن تكون العنصر الرئيسي في مكافحة تنامي ظاهرة الإجرام والإرهاب العابر للحدود وفي الحد من توفير ملاذات للمجرمين والإرهابيين وحواضن لفكرهم. ولا يمكن للتنمية وحدها أن تحد من الجريمة والإرهاب، بل تحتاج لكي تكون أكثر فعالية أن يتم دمجها في نهج متعدد الجوانب وأوسع ضمن سياسات إستراتيجية أمنية تبتعد عن خيارات القمع التقليدية بمفردها التي قد تُولِّد المزيد من العنف وتعمّق إشكالية الإرهاب والعنف المضاد.
ويمكن لهذه السياسات الإستراتيجية أن تستخدم أدوات "القوة الناعمة".فالوسائل والخطط الأمنية، رغم ضروريتها وبالغ أهميتها، لم تعد كافية في الوقاية أو المواجهة المطلوبة بمفردها، لأنها لا تتعامل غالبا مع أسباب انعدام الأمن وطرائق علاجه ولاسيما بعد أن تطور الفكر والتنظيم والتخطيط الإجرامي والإرهابي وتنوعت أساليبه وتعددت أهدافه، بسبب ما أتيح لأصحابه بفضل تطور تقنيات المعلومات والاتصال والنظام المعولم والمفتوح ، من الوسائل والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
ولقد عرفت موريتانيا منذ 2008 محاولات تستحق الوقوف عندها وتثمينها لمحاربة الإرهاب والجريمة وإحلال الأمن والسلم خاصة في منطقة الصحراء. فقامت الدولة الموريتانية في هذا المسعى بتجربة مهمة وفريدة نوعا ما وهي انتداب بعض العلماء والدعاة إلى السجناء السلفيين لمحارتهم وإرجاعهم إلى مبادئ الإسلام السمحة وفتح آفاق حياة اجتماعية متصالحة مع الآخر أمامهم.
ومن ضمن هذه المحاولات أيضا السعي في إنشاء تجمع يعرف بـ"مسار نواكشوط” (Processus de Nouakchott)؛ وهو مبادرة يرعاها الاتحاد الأفريقي ، وتضم كلا من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد بوركينا فاسو والسنغال وليبيا والجزائر وكوت ديفوار وغينيا ونيجيريا وأطرافا أوروبية.
وحسب وثيقة انيامي الصادرة عن مؤتمر وزراء خارجية المسار الثالث، والتي تشكل إطارا مرجعيا؛ فإن التجمع يهدف في جانبه السياسي إلى مرافقة تعزيز مكتسبات السلم والأمن بمنطقة الساحل وترقية دولة القانون والمساهمة في تدعيم المؤسسات الديمقراطية لاسيما حماية حقوق الإنسان والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني.كما يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والأمن على الحدود وتقوية قدرات مصالح الأمن والاستخبارات في منطقة الساحل الأفريقي، ودعم الحلول السياسية التوافقية والتنسيق الأمني؛ لمواجهة “الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود”.
كما تبنت موريتانيا فكرة إنشاء منظمة إقليمية(Stratégie, sécurité et développement G5) تهدف إلى وضع إستراتيجية للأمن والتنمية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس وشاركت فيها بنشاط. وفي الحقيقة فإن هذه المنظمة التي تضم كلا من موريتانيا، واتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي،قد اعتمدت الإستراتيجية الموريتانية لمكافحة التطرف العنيف التي تبنت مقاربة تقوم على مكافحة الفقر والهشاشة وخلق بنية تحتية تستجيب لمتطلبات المواطنين في الوقت الذي تعمل على رفع التحدي الأمني بوسائل الردع.
من أبرز التحديات الأمنية الأكثر خطرا التي تواجه أعضاء مجموعة دول الساحل الخمس: حالة الحرب في ليبيا، والجماعات المتطرفة الناشطة في غرب إفريقيا ، إضافة إلى أدلجة الشباب البَطال واكتتابه للقتال في صفوف هذه الحركات وخطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تعد من أهم مصادر تمويل الحركات المتطرفة.
و تمثل الإستراتيجية الموريتانية في ميدان محاربة التطرف العنيف مقاربة واقعية ومقنعة لإرساء الأمن بشكل دائم، ودعم تنمية مستديمة في المجال الساحلي الصحراوي.
محمد عبدالله الطالب اعبيدي
باحث دكتوراه فى القانون
مسؤول قطاع الأمن والدفاع
مركز "الدار" للدراسات والبحوث


.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)
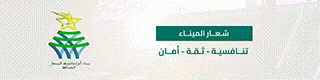










.jpg)