
عند مناقشة قضايا النهضة والتنمية في السياقات التاريخية والاجتماعية، نجد أن هذه المفاهيم غالبًا ما تُتصوّر من خلال مرجعية نابعة من سياق تاريخي وحضاري واجتماعي غربي، تُفرض كإطار نظري عالمي.
غير أن التجارب التنموية أثبتت مرارًا أن نجاح أي مشروع تنموي أو نهضوي يعتمد على انبثاقه من السياقات الثقافية والاجتماعية للمجتمع الذي يُطبق فيه؛ فالمفاهيم المستوردة، التي تبدو "عالمية"، تواجه تحديات جوهرية عند تطبيقِها في بيئات مختلفة جذريًّا عن تلك التي نشأت فيها.
إشكالية كونية المفاهيم التنموية
يشير مبروك المنصوري إلى أنّ كونية المفاهيم الغربية ليست سوى "وهْم"، لأنها نابعة من مسار حضاري غربي صيغ لتلبية حاجات محددة.
وقد استعاضت المقولات ما بعد الحداثوية عن مصطلح "كونية المفاهيم" بمفهوم "نسبية المفاهيم"، ما يعكس إدراكًا متزايدًا لضرورة احترام خصوصيات المجتمعات المختلفة بدلًا من فرض نموذج عالمي تُفترض صلاحيته لكل زمان ومكان.
شهدت موريتانيا في منتصف القرن العشرين تحولًا جذريًّا في بنيتها السياسية والاجتماعية، تزامنَ مع دخولها في سياق تاريخي معقد فرضته القوى الاستعمارية الأوروبية
النموذج التنموي الغربي والصدام مع البنى المحليّة
إنّ مشاريع النهضة في أوروبا الغربية استندت إلى تراكُم تاريخي داخلي من التحولات الثقافية والاقتصادية، انعكاسًا لحاجات مجتمعية خاصة بتلك السياقات. أما في الدول المصنّفة ضمن العالم الثالث، ومن بينها موريتانيا، فقد كانت النهضة أو التنمية مشروعًا مفروضًا من الخارج.
إذ تبنّت هذه الدول نماذج التحديث دون مراعاة خصوصياتها الثقافية والاجتماعية، ما أدى إلى فجوات هيكلية عميقة بين الدولة والمجتمع؛ فالتبني الآلي للنماذج المستوردة حال دون تحقيق انسجام بين المشاريع التنموية والبنى التقليدية القائمة، ما أدّى إلى تصادم مستمر بين النموذج المستورد والهياكل الاجتماعية المحلية.
موريتانيا والاستعمار: التأسيس الفوقي للدولة
شهدت موريتانيا في منتصف القرن العشرين تحولًا جذريًّا في بنيتها السياسية والاجتماعية، تزامنَ مع دخولها في سياق تاريخي معقد فرضته القوى الاستعمارية الأوروبية.
وقد كان تأسيس الدولة الحديثة أبرز ملامح هذا التحول، لكنه لم ينبع من تحولات داخلية تعكس تطورًا طبيعيًّا للمجتمع الموريتاني، بل جاء كنتيجة مباشرة للضرورات الاستعمارية.
وفي هذا الإطار، يشير بدي ولد أبنو إلى أن الدولة الموريتانية "وُلِدت كمعطى فوقي خارجي مفارق، أي كنموذج حدّي أو أوجي للدولة ما بعد الاستعمارية".
اعتمد الاستعمار الفرنسي على خطاب عسكري يروّج لسياسة "السلم المتبصر"، وهو خطاب برر السيطرة الاستعمارية وغطَّى على استغلال الموارد والثروات المحلية، وبعدها انتقل إلى خطاب "التنمية"، دون أن يأخذ في الحسبان الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.
وقد ركزت السياسات الاستعمارية على تحويل المستعمرات إلى كيانات اقتصادية تخدم حاجات فرنسا، ما جعل موريتانيا تبدو كدولة "مواد خام"، مع سيطرة فرنسا على الموارد الطبيعية دون أن تساهم في بناء مؤسسات تخدم المجتمع المحلي.
التنمية بعد الاستقلال: الاختزال الثقافي والاقتصادي
مع استقلالها، وجدت الدولة الموريتانية نفسها مفصولة عن السياقات الاجتماعية والثقافية المحلية، ما أثر على مسار تطورها؛ فبينما سعت الدولة إلى تبني التصنيع كأداة أساسية للتحول من الاعتماد على القطاع الرعوي والزراعي التقليدي إلى الاقتصاد الصناعي، أهملت التوجهات التنموية القطاعات التقليدية التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني، مثل الزراعة والرعي. وقد أدى هذا الإهمال إلى ركود هذه القطاعات، بدلًا من استثمارها وتطويرها بشكل يعزز التكامل بينها وبين التصنيع.
هذا التوجه يعكس رؤية اختزالية تهدف إلى التحديث دون مراعاة للهويات الثقافية؛ وكما أوضح جلال أمين في كتابه "خرافة التقدم والتخلف"، فإن نظرية روستو في مراحل النمو الاقتصادي افترضت انتقال الدول من مراحل "التخلف" إلى "التقدم"، بما في ذلك تحولها من حالة ثقافية متدنية إلى أخرى أرقى، وهذا ما يتماشى مع السياسات التنموية التي اتبعتها موريتانيا، حيث تم استيراد نموذج صناعي غربي دون مراعاة للخصوصيات الثقافية، ما أدى إلى أزمة هُوية بين التقليد والحداثة.
يمكن القول إن التنمية في موريتانيا بعد الاستقلال لم تكن محايدة؛ إذ لم تنبع من السياق الثقافي والاجتماعي المحلي، بل فرضت نفسها كتوجه ثقافي غربي أدى إلى أزمة هوية وطني
تجربة الهند: نموذج مغاير لدمج التقليد والحداثة
في مقابل النهج التنموي المفروض، تقدم التجربة الهندية نموذجًا مختلفًا، حيث اعتمدت على نظام البانشايات (مجالس القرى) كنموذج للحكم المحلي، ما سمح للمجتمعات بالمشاركة الفعالة في صنع القرار.
تاريخيًا، كانت البانشايات تُستخدم لحل النزاعات المحلية، لكنها تحولت بعد استقلال الهند إلى مؤسسات رسمية ذات صلاحيات قانونية، ما عزز من شفافية الإدارة وشجع على التنمية المحلية.
تم تعديل الدستور الهندي عام 1992، ليمنح هذه المجالس صلاحيات موسعة في إدارة التنمية المحلية، ما أدى إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية.
ورغم التحديات، فإن التجربة الهندية تُظهر كيف يمكن تحقيق التنمية من خلال تمكين المجتمعات المحلية، واحترام الهياكل التقليدية بدلًا من فرض نماذج خارجية لا تتناسب مع الخصوصيات الثقافية.
الخاتمة
يمكن القول إن التنمية في موريتانيا بعد الاستقلال لم تكن محايدة؛ إذ لم تنبع من السياق الثقافي والاجتماعي المحلي، بل فرضت نفسها كتوجه ثقافي غربي أدى إلى أزمة هوية وطنية.
كما أن إهمال القطاعات التقليدية فاقم من هذه الأزمة، حيث تدهورت الزراعة والرعي، وغيرهما من الأنشطة الاقتصادية التي كانت تشكل قاعدة الاقتصاد الموريتاني التقليدي.
ومن هنا، فإن التحدي الأساسي أمام موريتانيا اليوم يكمن في التوفيق بين الحديث والتقليدي، وتطوير سياسات تنموية تراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، بما يحقق تنمية مستدامة وشاملة.
إن دراسة تجارب مثل الهند قد توفر دروسًا قيمة لموريتانيا، حيث أظهرت الهند كيف يمكن الا
ستفادة من الهياكل التقليدية لتطوير نموذج تنموي متوازن.
إبراهيم أحمد الشيخ سيديا

.jpg)
.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)
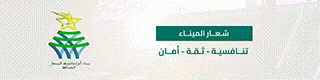










.jpg)