
تُعتبر المناصب السياسية ذات الطابع التشريعي أو التدبيري (تدبير المجال وتسييره)، من أهم المناصب التي يتبارى فيها المتبارون و عليها يتنافس المتنافسون، ولأجلها تبرز صفوة الصفوة، التي يناط بها إدارة الشأن العام تدبيرا للمجال وسنا للقوانين التي تضبطه وتؤطره.
فالذي يتقدم إلى هذه المناصب مستشارا بلديا كان أو عمدة أو برلمانيا، يفترض فيه أن يكون مُلِمًا بالخطط الإستراتيجية للتنمية المحلية،
وأن يكون على دراية بواقع الناس، آلامهم وآمالهم، والاكراهات المجالية التي تُكبِّل عوامل النمو والتطور، والقصور في الخطط التنموية التي شهدتها منطقة المترشح من المستوى المحلي إلى المستوى الجهوي فالمستوى الوطني، حتى يتسنى له أن يبني برامجه الانتخابية على خطة أو خطط تنموية واضحة المعالم وبأهداف محدده لا تتسم بالهلامية في الطرح ولا بالزيف في وعود عرقوبية لا تفتأ أن يكذبها واقع ما بعد تقلد المنتخب، هذا المنصب أو ذاك.
كما يجب أن يكون المترشح أو المرشح على دراية وإلمام بالقوانين التشريعية في البلد، إذ لا يُعقل أن تُوكل مهمة سن القوانين وتنقيحها أو الاعتراض عليها -إذا ما كانت معيبة بمخالفتها لروح الدستور ومقتضياته- لهيئة أعضاؤها أو البعض منهم لا يكاد يُعرِّف مفهوم القاعدة القانونية، أحرى أن يكون على اطلاع بالقانون وتشعباته والدستور ومقتضياته.
فَأنىَّ لهيئة ذاك وسمها أو البعض من أفرادها، تلك الجدارة العلمية في أن تصادق على مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة أمام أعضاء البرلمان.
لقد حدَّ من فاعلية هذه الهيئة، الموسومة بالتشريعية –عبر تاريخها- القصور الحاصل في المستوى القانوني لأفرادها، فليس كل مثقف يصلح لسن القوانين ودراستها وتمحيصها، وليس كل وجيه اجتماعي يصلح لهذه المهمة.
وقد ظهر عدم مراعاة تلك الأبعاد جليا في الضعف الكبير لأعضاء الهيئات التشريعية، أمام الجهاز التنفيذ ممثلا في الحكومة، إذ لم يحصل أن اعترضت الغرفة التشريعية على مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة، ولم يحدث أن تم حجب الثقة عن حكومة ما لسوء أداء أو تسيير، فالرقابة البرلمانية على سير عمل الحكومة ومرافقها الإدارية تكاد تكون معدومة لانعدام فاعلية الجهاز التشريعي مما خلق تغولا متناميا للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وصلاحياتها، والأسئلة الشفوية أو الكتابية المقدمة من طرف أعضاء البرلمان تكاد تكون معدومة، وإن وجدت فلا تؤدي دورا يذكر في المحاسبة والتحقيق ولا تفضي إلى نتائج ملموسة.
لقد ظل دور أعضاء هاتين الغرفتين مقتصرا على رفع الأيدي بالتصويت على ما تعرضه الحكومة من معلبات لمشاريع القوانين، ولولا مخافة ادعاء هذه الأخيرة احترامها مبدأ الفصل بين السلطات واحترام اختصاص كل منها، لسنت لنفسها القوانين دون الرجوع إلى هيئة عجزت حتى الآن عن خلق تشريعات تسهم في تطوير الترسانة القانونية في البلاد ضمانا لحقوق الفرد والمجتمع، وتحقيقا لعدالة غاب فيها المشرع، الذي كان من المفترض أن يمثل إرادة الأمة وسلطتها وسلطانها.
إن حمى الترشحات والترشيحات التي نشهدها الآن، لتطرح وبحده تساؤلات عميقة من قبيل من يريد أن يشرع لمن؟ ومن يريد أن يسوس من؟ فهل سيبقى تدبير الشأن العام مفتوحا لكل من هب ودب... دون مرعاة الكفاء العلمية صاحبة الاختصاص؟

.jpg)
.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)
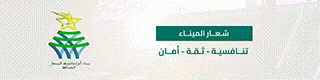










.jpg)