
وكالة الوئام الوطني - عودنا الشاعر والروائي الموهوب المختار السالم أحمد سالم على استثارة القراء كل مرة وهو يقدم إحدى تجاربه الكتابية نثر وشعرا؛ فمن فترة هجر القالب العمودي حتى لتكاد تشك أنه خبره في بداياته، وأن فنانين مرموقين لحنوا قصيدته الذائعة:
لئن جنيت على نفسي سأعترفُ
قد يغفر الله للعشاق ما اقترفوا
لقد انساق لتيار الحداثة غير هياب ولا وجل، وجاءت دواوينه الأخيرة تناغما للقصائد النثرية والتفعيلة.
وها هو اليوم يطل متبجحا ممسكا بتلابيب الشكل الخليلي، متخذا من البحر البسيط مركبا ذلولا لتأطير تجربته، يعزفه فيها متفننا في تفصيله مقطعيا وشطريا وتاما.
ينفتح النص منذ العتبة الأولى على التهليل للامألوف والخارج على القيود، هكذا أراد أن يفتح عالم القصيدة على كل ما يخالف معايير المألوف، ومواضعات المجتمع:
ما أرْوَعَ الخَبلا
والإثمَ والزللا
والجنَّ والدجلا
والتيهَ والكسلاَ
والريْـحَ والطَّـفَـلاَ
والقيظَ والخللا
ما أطـْـيَبَ المـَحَـلاَ
والبومَ والجُـعَـلا..
أية عوالم تلك التي يمتح منها الشاعر خيوط لعبته اللغوية؟
ولماذا كل هذه المحذورات والمكروهات دفعة واحدة؟
هي لعبة الشاعر مع المخالف والمغاير من أجل أن يكون ويتميز، أوليس الشعر مسا من الشيطان، وتيها في أودية عبقر ومراودة لساكنيها من الأتباع والجن.
شكلت الصورة في هذا النص أطرافها وألوانها من متعاطفات خارجة على نسق الروعة المعروف لدى المتلقين: (الخبل – الإثم – الزلل – الجن – الدجل – التيه – الكسل- الريح – القيظ – الخلل – المحل).
فالشاعر منساق لروعة وطيبوبة هذه المفردات التي تتخذ لها مرجعيات هي أبعد ما تكون عن لفت الانتباه في النسق المعهود، إن لم نقل إنها مدعاة للتنفير والرفض؛ فهي صفات منبوذة في العرف الديني والأخلاقي: (الخبل – الزلل – الإثم – الدجل – الكسل- الخلل)، والمفردات مشحونة بالرهبة والخوف: (الجن – التيه – القيظ – المحل – البوم – الجعل).
غير أن حضور الذات الشاعرة يأتي معلنا فتحا جديدا في هندسة النص، يشكل الشاعر من خلاله اللغة بحثا عن المعنى وذلك في قوله:
أنا الذي عــذَّبَ المَـعْـنى معــازَفَـهُ
ورامَ عـنْ أهْلهِ كَـهــفًا لــيعْـــتـزلا
والناسُ منْ بينهمْ جِسْرٌ تقـوَّسَ لي
لكنهُ بعْـدهَا أغْــرى بيَ الـــوُكَــلا..
إن حضوره حضور اعتداد واستعداد، يحمل إلينا أنفاس أبي الطيب المتنبي حين يقول:
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي
وأسمعت كلماتي من به صمم
غير أن الشاعر المختار السالم يعرف نفسه بأنه اللاهث خلف المعنى، والمتبتل في محراب الوحدة، ليكتشف سر العذاب ومكابدة الخلق والإبداع.
وإذا كان المتنبي يقدم نفسه بأنه من أنجز معجزة إبداعية تعيد للأعمى نظره وللأصم سمعه، كما هي آية عيسى – عليه السلام – فإن شاعرنا يثير مسألة الإنجاز الإبداعي الذي أوهمه المتلقون بالعبور على جسره ولكنهم نكثوا العهد.
ويستثمر الشاعر العديد من الرموز المحلية تجذيرا لتجربته الإبداعية، وتأصيلا لها في التربة المحلية، فتأتي الأسطورة (خوخو) المنقولة من مرويات الصغار لتخويفهم حين يخالفون أوامر الأمهات:
كأنَّ “خوخو” (كبيرُ الجِنِّ) عوذهم
قرونَـهُ، فاستفاقـوا خوْفَه “فُـضَلا”
وحين ألقى على بِــئْـرٍ تمائمــــه
ثم اختفى وإناءُ الناسِ قــــدْ وَدَلاَ..
وجفَّــفَ الــدمَ من لحْمٍ إلى شَجَرٍ
جفْــلٍ على كلِّ طبْعٍ سيِّـئٍ جُبِلاَ.
هكذا يتبدى وكأنه طائر الفينيق ينبعث من رماده مجددا كلما حاصره الزوال، ليسلك دورة الحياة وهو أنقى وأبقى:
هذا هو الليلُ هلْ أنْـثى تُراقِصُني
تحْتَ الرَّمادِ.. على رتْلٍ فنـتَّــكلاَ…
يتكئ الشاعر على مدونات راقية في إحالاته التناصية، تبرز غنى مخزونه الثقافي؛ فلئن برزت ظلال المتنبي في الأبيات السابقة واضحة، فإن ظِل الشاعر السعودي محمد الثبيتي لم يغب كذلك؛ ومن ذلك قوله:
أفقْ.. وصُبَّ لنَا جمْرًا.. بسُمْرتهِ
تَـوَرَّدَ الأفْقُ.. إنْ عفَّ الذي عُزِلاَ
وقلْ أعوذُ بربِّ الناسِ منْ سَعَـــفٍ
لا ظِــلَّ فيْهِ لمنفى.. عنْ يدِ البخلا..
ففي هذا المقطع محاورة وطيدة لقصيدة محمد الثبيتي (تغريبة القوافل والمطر) حين يقول:
أَدِرْ مهجة الصبح
صب لنا وطنا في الكؤوس
يدير الرؤوس
وزدنا من الشاذلية حتى تفيء السحابه
أدر مهجة الصبح
واسفح على قلل القوم قهوتك المرة المستطابه
أدر مهجة الصبح ممزوجة باللظى
وقلب مواجعنا فوق جمر الغضا
ثم هات الربابه
هات الربابه…
ولا شك أن ما يجمع بين الشاعرين واضح جلي، فكلاهما ابن الصحراء المفتون بها، والذي حمل قسرا إلى المدينة، وكلاهما يستند إلى موروث تراثي مشترك بتضاريسه وشعرائه وأساطيره، وإن اتسعت الرقعة. وكلاهما يستنبت الشعر في مجتمع ما يزال يحيط إرثه الثقافي والاجتماعي بالكثير من التقديس، ويجد عنتا في الخروج عنه إلى الحداثة وتجلياتها.
ويأتي النص القرآني بدوره حاضرا في القصيدة، متخللا أبياتها ومقاطعها، فهو يوظف قصة أصحاب السفينة في سورة الكهف وما حف رحلتها من المخاطر:
هي الموانئُ أغبتْ ثُـقْـبَـها سُفنٌ،،
فكانَ وجهُ “التَّغَافي”.. هكذا نُـقِلا!
… وحدِّثِـيْـني بلا سِتْرٍ.. فكمْ مُقَلٍ
عَرائسُ البحْرِ فيْها تَـنْشُرُ الكَحَلا؟
إنها رحلة في بحر التاريخ العربي الإسلامي، يسترجع الشاعر لحظاتها المضيئة، وهو المكتوي بنار الواقع الأثيم:
وإنَّ لليُوْسفيِّ الخيلَ مُعجزةٌ، لهُ: هناكَ وعاءٌ واحدٌ،، يتلاونُ انتباهًا على أوتارهِ؛ غَسَقًا؛ على الشِّغَافِ منَ اللاَّلوْنِ قدْ زهلا..
لا فوْقَ أندَلسٍ أوْ بعْدَ أندَلسٍ،
مَعَاشُنَا المـَـوْتُ في الحلْمِ الذي انفعلاَ..
فاليُوسفيٌّ عليْنَا أنْ نَراهُ يجاملُ البلابِلَ.. في عزِّ الخواء دَلَالاً واحداً.. نَسأ الطلحَ “المُـنَسَّأَ” في أوراقهِ فتفانى اللطفُ أن يصلا..
وإذْ تورَّقَ أشبَاحاً وأٌقمشةً، وجَالَ مسْتعتِـباً لا وارفاً بسلا.
فيحضر ابن تاشفين الفاتح العظيم، وتتراءى الأندلس؛ الفردوس المفقود، ويطل الحاضر المحمل بالعذابات والإحباطات.
كلها عوامل تتحد وتتضافر تباعا لتضرب بسهامها في قلب الشاعر الحامل هم أمة وتاريخ، ولكن اللغة تأتي لتمنحه دفئها فينطلق معتنقا رحلته التليدة نابذا ما سواها في تحد مشهود:
واصبرْ على ما يقولُ المرجفونَ فلنْ
يروقهمْ أنَّ شعْـراً يـَمْدحُ النبلاَ
ولا غرابة إنْ مجَّوا قصائدهُ
تبقى الرطانةُ ألبابا لدى “النُّخَلا”…
هدِّءْ ولحـْـنَكَ “حَنِّنْ”.. كلُّ مُنتبذٍ
بهِ مَنَ النخْلِ ما يكْفي لتنشتلا..
عَـزَفْتُ فوْقَ ظهوْرِ العِيْسِ قافيتي،
لا يَـعْرفَ اللحْنَ منْ لمْ يَركبِ الإبلا..
هكذا يصل الشاعر إلى حكمة مقررة أملتها تجربته وعضدتها شواهد التاريخ، فاللحن لا يكون إلا والشاعر ينتضي الناقة، ويرجز الحداء.
ويرتحل الحادي ظنا منه أن النجاء سيكون ولكن هيهات! لم يعد بمقدوره غلاب التصحر والقهر في وطنه الكبير، وكلما أوغل في السير تبدت سوءات البلاد وعبث المعتدين بها:
واليومَ طـلَّــقْتُ “لاءاتي” فزوَّجني
ندائِـيَ المُــرُّ من ياءاته كسلاَ..
بغدادُ لا قطرةٌ في دجْلةٍ خَطَـرَتْ،،
بعدَ “المجيْدِ” تَشظىَّ دجْلةٌ رمَلا..
وجنـتا عَدَنٍ في وجْـنتي عَدَنٍ
طعْم الصَّريْـمِ كطعْمِ الدهْر إنْ مَذَلَا!
كمْ سَارَ من ثارَ في “تجييْف” أمثلةٍ
والحلمُ أرملهُ جَفْنُ الغضى سَفَـلا؟
فتحْتُ للظلِّ أسواري بمرتفعٍ
فما ترفَّـــعَ في مَعْنَاهُ مرتجلاَ!..
يا نافحَ الليْلِ لا تشْكُو إذا عَـثَـرتْ
خطاكَ.. “إن اعوجاجَ الطبْعِ ما اعتدلا”..
فَنَجِّـم النارَ عنْ دُخَّانها سُحُبًا
ورجِّ للشمْعِ أضواءً إذا اشتعلا
القصيدة ملحمة طويلة النفس جاءت أبياتها بعدد أيام السنة، وتمفصلت تحت عناوين مثيرة يصلح كل منها عنوانا لديوان: (سالمية وهو العتبة الكبرى التي صدرت عنها بقية العتبات: الحمام المعتدي – كان ضوء – المقطع صفر تحت النار – المقطع نار تحت الصفر– كهف بلا وصيد – كهف مدينة الكلاب – عالم النسور الحمر– المدينة وبياض المرايا – إجازة مرضية – تقوست أسماؤنا – الفيال – مفتي الشيطان – عش للأفق – أعشاب غير عربية – الجبل المتردم – البحر الغريق).
هي عناوين مختلفة المرجعيات توهم القارئ أن هذه القصيدة الملحمة مؤلفة من نصوص مختلفة، تعتمد كل منها عتبة خاصة، غير أن المتمعن للنص يجد أنه لم يكن إلا نصا واحدا، منسجم الدلالة، موحد الإيقاع والروي، كتبه الشاعر متمهلا وهو يتأمل عالمه المفعم بالتحولات والتناقضات، ويستعيد تاريخه الممتد بامتداد الكينونة العربية في محطاتها المختلفة.
حاول التمرد والتخلص من أدران خطيئة هذا العالم عبر البوح وكشف المستور، واعتمد الرفض سبيلا، والرحلة الوجودية مركبا، ولكن عالم الظل ظل يمتد أمامه ليثبت له أنه لن يتحلل من ربقة الزمن ولا من أدران الإنسان مهما تسلق الجبل وآوى إلى النار:
فَنَجِّـم النارَ عنْ دُخَّانها سُحُبًا
ورجِّ للشمْعِ أضواءً إذا اشتعلا.
لذلك وفي آخر مقطع يؤوب الشاعر إلى إيمانه العميق، ويثوب إلى ربه خاشعا متبتلا بعد أن أعياه حمله الثقيل وليله الطويل ومجتمعه الكليل عساه يستشعر الراحة ويخلد إلى هدأة بعد أن دارت عليه أيام السنة معتنقا الرحلة وباحثا عن زهرة الخلود:
تكلْ على الله تغدو فائزا أبدًا
“ما خابَ عبْدٌ على الله العلي اتكلا”.
سنزرعُ الظلَّ في الأشجارَ منْ دَمِنَا
ونجعلُ الماءَ في الدَّهْرَيْنِ مُنْـتَـقِلا
ففي الهديلِ ارتواءٌ كلهُ عطشٌ
والبدءُ منْفى لإسماعيْلَ مُعتـزلا.FacebookTwitterWhatsAppPartager


.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)
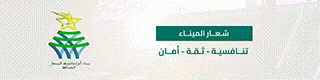










.jpg)